علي عبد الأمير عجام يقتلني، أو يكاد، حلم إمتلاك بيت صغير على شاطىء نهر من أنهار بلادي، بيت يشبه ما أحببته في هذه الحياة، وما وطنّت نفسي عليه، وما خلصت إليه من مسار، ولأنني ابن "حظ عراقي دراماتيكي ضربني ضربته القدرية"، بات هذا الحلم، بما يترتب عليه من "سند طابو"، مستحيلا بل كابوسا، حتى جاء من يعوضني ألم فقدان البيت وحتى الحلم به، إنه كتاب "توبوس" (طابو بالعربية أو التركية) للمعمار والمثقف العراقي معاذ الآلوسي. هو نشيد محبة شديد الصفاء والرهافة للعراق ولبغداد تحديدا، عبر نص شخصي (يمكنك اعتباره مذكرات)، يقدم خلاصات عميقة تتعلق بالمكان وأهله، بالحوادث الكبرى التي شهدتها البلاد، وبالواجبات المهنية والإنسانية التي تصدى لها صاحب المشروع الحضري المميز "شارع حيفا" ببغداد، في سيرة تمتد من نهاية أربعينيات القرن الماضي حتى يومنا الحالي حيث الألوسي في "مدينة ليماسول (قبرص) التي توفر أكثر ما أبتغيه ومعها لا أريد ذلاً مؤبداً ولا عيشاً منكداً"، مرورا بدراسته للهندسة المعمارية في أنقرة بتركيا ثم تدريبه العملي في ألمانيا فعودته إلى "الرحم" بغداد للعمل ثم الدراسة المتخصصة في بريطانيا فالهجرة الأولى ثم العودة إلى "الأم" من أجل "تسجيل معمارية المدينة القديمة على نحو أكثر إنتابها وعلمية"، فالهجرة الثانية التي ظلت مفتوحة على لطف الآلوسي وشخصيته الآسرة رغم الحزن الهائل الذي تنطوي عليه ورغم كونه "أبو دميعة" من طراز خاص، فهو في أواخر كتابه الصادر حديثا عن "دار الجمل-بيروت" يقول: "عيني وقلبي على بغداد. هناك لي دار مكعب يطوف على شاطىء دجلة، وضعت فيه كل ما نهلت من قيم جمالية ومقومات حياة جميلة، الآن هو مقفل، ربما يقفل ويصبح طللاً، ربما يكتب لي العودة إليه، ومنه إلى السبات الأبدي في إحدى زوايا الشيخ جنيد".
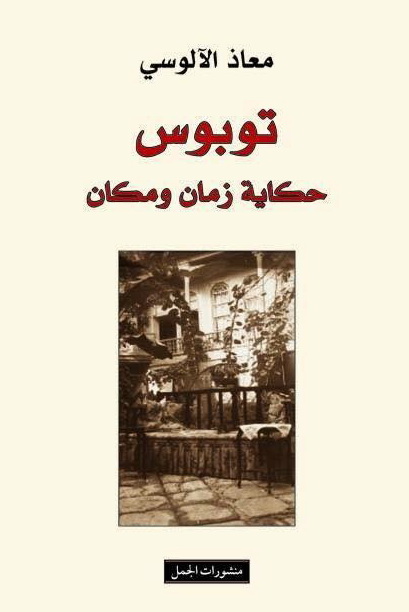
دروس الآلوسي كتاب "توبوس" له صلة من نوع ما بآخر أصدره الآلوسي قبل خمس سنوات وحمل عنوان "نوستوس" أي الحنين أو "النوستالجيا". والصلة هنا لا السجل التذكاري الذي صاغ العملين وحسب، بل في التدوين النادر عن أحداث عاصفة وتحولات هادرة عاينها الكاتب وخبرها شخصيا، فهو على نقيض معظم الدراسات الثقافية والمدونات الشخصية (المذكرات) بقى بعيدا عن التأويل الفكري والسياسي لتلك الأحداث والتحولات، وظل يرنو إليها عبر ما تتركه من تأثيرات على المصائر الإنسانية وبقدرة هائلة على الإيجاز، وهذا درس أول بارز من دورس الآلوسي في كتابه. فثمة عشرات البحوث والدراسات كتبت وستكتب أضعافها في حدث مهم في تاريخ العراق المعاص مثل 14 تموز 1958، لكنك لن تجد مثل هذا الإيجاز الذي دونه الآلوسي للحدث الذي عاد من أنقرة إلى بغداد كي يتعرف على ما جرى " لقد رفعت الجثث والحبال، لكن سمعنا قصصا تثير الإشمئزاز، ورأينا جموعا ما زالت جامحة تركض وتهتف..." وصولا إلى "كان هناك معسكران يصدران ضجيجا. عدنا إلى قواعدنا بعد أن إطمأن الأهل علينا، لكنهم هم من فقد الاطمئنان". وفي الإطار ذاته تأتي إشارته الإنسانية الجوهر إلى إنقلاب 8 شباط 1963 "رأيت بسمارك عزيز رئيس القسم يهان بطريقة بشعة، مصطفى يعتقل، المهندس محمد محمود يختفي. بات الكثير من الأصدقاء نزلاء سجون، رفعة حجزت أمواله، إبراهيم علاوي اختفى". صحيح أن الآلوسي يؤكد كراهيته للعمل السياسي، وقد يكون مقتل ابن عمه قيس في وثبة 1948 سببا لتلك الكراهية المبكرة، لكنه يترجمها إلى مواقف وطريقة رصد لتلك الأحداث والتحولات التي عناها الصراع الأيديولوجي والسياسي الحزبي في العراق المعاصر الذي ما لبث أن صار صداما دمويا وتحديدا بعد العام 1958. ومع ذلك فهو يظل في العميق من الرؤية السياسية لجهة كونها تنظيم العمل بين السلطة والناس عبر مجالات عمله الأثيرة: التصميم المعماري بما يعنيه تذليل الصعاب وتقليل التوحش ورفع مستوى الأنسنة، بل هي كما يعرفها "السياسة الحقة مرادفة لكلمة تنمية مستدامة". ولا يصف الآلوسي تلك الحوادث وأهوالها على نحو تقريري فج، بل وفق منظوري شخصي روحي محض "هذا الحدث (مقتل قيس الآلوسي) مع أحداث أخرى في مراهقتي، آلمني كثيراً وقرّبني من ذلك الحزن القائم في حياة العراق السياسية والاجتماعية، كان ألما بمقياس كبير كمقياس الرسم، ثم راح يتضخم ويحفر داخل الذاكرة"، لنراجع الوصف المبتكر والشخصي " كان ألما بمقياس كبير كمقياس الرسم" أي بنسبة واحد (الرسم) إلى عشرة آلاف (الواقع) أو واحد إلى مئة ألف أو مليون حتى، لجهة تحويل الحدث الشخصي (واحد) إلى آلاف في بعده الحقيقي الوطني. ليس هذا الدرس وحسب، فالآلوسي معلم كريم يجود على تلاميذه برضا يقارب الحبور والإمتنان، فهو يقصي بشكل جذري ولكن بلا صخب، ذلك الرأي الصلف والمتوحش الذي يكثر على العراقي المغترب دراسة وطنه على نحو مختلف عن الصخب السياسي والاجتماعي: صخب العقائد والأحزاب والولاءات المتسيد لمشهد البلاد منذ أكثر مننصف قرن، عبر مواقف ومشاعر تمتد على طول الكتاب (من هنا وصفي له بنشيد المحبة) وتتركز في قوله "أنا الموجوع من الوطن، المهزوم منه، وكلي شوق إليه، أعيش بعيداً عنه وأتابع ما جرى ويجري عليه من تخريب منظم في جميع مناحي الحياة. هناك تشويه للهوية الوطنية، وعلى وجه التحديد تشويه للروح البغدادي الذي هو اللب المنظم والمتحضر من الوطن العراقي". ومن بين دروسه الفذة، ذلك الفيض الكبير من المعرفة لحوادث وشخصيات وحكايات يسردها على غير النحو الذي كانت ثابتة عليه في الذاكرة الثقافية والوطنية، فثمة معلومة مختلفة وقيمة عن منفذي "فرهود" بغداد الذي طال يهودها "من أين أتى الغوغاء(المنفذون للفرهود)؟ إنهم غرباء عن بغداد. والمدينة كانت مركزا لتعايش هادىء ومنتج بين الطوائف. كان اليهود من البغادة الأصلاء في السلوك الحضاري وحب مساعدة الغير"، ليخلص بعد ذلك إلى ما أجده خلاصة ذهبية عن "فرهود" جماهيري تارة ومليوني تارة أخرى: "منذ ذلك الحين سيمارس الغوغاء دورا مدمرا في الحياة البغدادية، وفي حياة المدن العراقية كلها". وما يتصل بـ"ترييف المدن" أو "تدمير الحياة البغدادية" يورد الآلوسي ما تبدو حكاية صغيرة أو تفصيلا عابرا، لكنه شديد الأهمية لجهة علاقة السلطة الريفية الجذور بالمكان المتحضر، فثمة قرار صدر في سبعينيات القرن الماضي، يقضي باقتطاع جزء من مدرسة التطبيقات في الأعظمية، وهي ملمح ليس تربويا وحسب بل مدنيا راقيا، من أجل بناء مركز للشرطة. القرار هذا وما ترتب عليه يعكس همجية السلطة وتركيزها على رموزها (مركز الشرطة) ودائما على حساب رموز التحضر والتمدن والمعرفة (المدرسة العريقة التي تضم أساتذة شكلوا روح النهضة الثقافية والتربوية العراقية ليس أقلهم: الموسيقار جميل بشير).
القسم الثاني غدا.
|